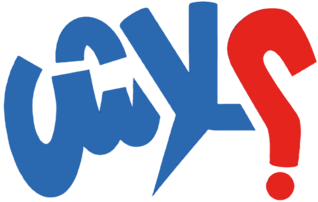اقتصاد الدكان: هروب الدولة إلى جيب المواطن!
تاريخ دول العالم مليء بلحظات الأزمات الاقتصادية الخانقة التي ضربت دولا فأنهكتها وأرهقتها، دول انهارت وأخرى نجت، وبين الانهيار والنجاة يكمن الفارق في القرارات التي تتخذها النخب الحاكمة في لحظات الخطر الحقيقية.
عندما تواجه الدولة أزمة مالية حادة، ونقصا في الموارد المالية أو زيادة في الإنفاق مقارنة بالدخل، فإن المنطق والعقل والحكمة تقتضي إعلان حالة الطوارئ الوطنية والبدء بحزمة إجراءات تقشفية، كتخفيض الإنفاق وإلغاء المشاريع الكمالية ومنع الاستيرادات غير الضرورية، وإيقاف السفريات والنثريات والسيارات والهدايا والمزايا للوزراء والمسؤولين، وتوجيه كل الموارد المتاحة نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، هذا هو ما يعرف بالتقشف، وهو عبارة عن جرعة دواء مرة لكنها ضرورية لإنقاذ المريض من الموت.
والتاريخ يخبرنا أن دولا عديدة نجت من أزمات اقتصادية خانقة بتطبيق برامج تقشف قاسية، منها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وبريطانيا في سبعينيات القرن الماضي، والأرجنتين في أزماتها المتكررة، واليونان التي كادت أن تغرق في بحر الديون، قبل أن تنقذها حزمة من الإجراءات التقشفية المؤلمة لكنها الضرورية والمنطقية.
أما عندنا في ليبيا، فالمنطق مقلوب، عندما تتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتتقلص الموارد، لا تفكر الدولة في خفض إنفاقها بل تتوسع فيه، لا تلغي مشاريعها الوهمية بل توقع عقودا جديدة لمشاريع أكبر بمصاريف أكثر، لا توقف هدر المال العام بل تستطيل فيه ويولد لنا الفساد مليونيرات جدد كل يوم، لا تقطع أيدي الفاسدين الذين نهبوا البلاد لعقود، بل تكافئهم بالمناصب والعقود.
إذا فماذا تفعل لمواجهة الأزمة والتغلب عليها؟ ببساطة تتجه الدولة إلى جيب المواطن البسيط، فتفرض عليه ضريبة جديدة؛ ليست ضريبة على أرباح الشركات الكبرى، ولا على رواتب كبار الموظفين، ولا على سلع الرفاهية والكماليات، كلا؛ الضريبة الجديدة هي على سعر صرف العملات الأجنبية.
قرار قد يبدو للوهلة الأولى تقنيا وبريئا، وظاهره حل الأزمة، ولكنه في الباطن خنجر مسموم في خاصرة المواطن الفقير، قرار ينعكس مباشرة على المواطن في صورة ارتفاع جنوني في الأسعار، ارتفاع في سعر الدواء والخبز والحليب والبيض والقرطاسية والمواصلات وكل شيء يمس حياة المواطن بشكل مباشر.
هذا النهج لن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة؛ تضخم محموم يؤدي إلى مزيد من الفقر، ثم انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه.
لأن الدول التي تخفض قيمة عملتها أو تعومها أو تتعامل مع سعر الصرف بهذه العبثية، هي عادة دول منتجة، تعتمد في دخلها القومي على الزراعة أو الصناعة أو السياحة، دول تتمتع باقتصاد متنوع يمكنه أن يتكيف مع المعطيات الجديدة، فيصدر أكثر أو ينتج أكثر ليعوض.
أما ليبيا فاقتصادها ريعي هش، يعتمد على النفط بنسبة تقارب 95%، ولا تنتج سوى القليل القليل مما تستهلك ناهيك عن التصدير، فكل ما نحتاجه نستورده من الخارج؛ بداية بالمسمار وصولا إلى السيارة، ومن حبة البانادول إلى حبة القمح.
رفع سعر الدولار بالنسبة للدينار يعني ببساطة أن تكلفة استيراد كل هذه السلع قد ارتفعت، والتاجر لن يتحمل هذه الزيادة في التكلفة، بل سينقلها فورا إلى المستهلك، إلى ذلك المواطن المرهق الذي راتبه ثابت لا يتحرك، الذي دخله لم يكن يكفيه قبل زيادة الأسعار، فكيف سيكفيه الآن بعد أن تصبح تكاليف الحياة أغلى؟
القرار في جوهره، هروب من مواجهة الأزمة الحقيقية، فهو علاج خاطئ لمرض خطير، هو كمن يعالج مريضا يتألم بسبب نزيف داخلي؛ بإعطائه مسكنا للألم، سيبدو بعد قليل أن الألم قد خف، لكن النزيف سيستمر من الداخل حتى يموت المريض.
الدولة التي تفرض الضرائب على شراب الناس وطعامهم، بدل أن تقتصد في إنفاقها، هي دولة تفكر كصاحب دكان صغير يقترض ليدفع ديونه القديمة حتى يستمر في إدارة دكانه البائس، هي دولة تدفن رأسها في الرمال، وتترك جسد الشعب يعاني من حر الشمس ولهيب الرمال.
والعواقب ليست اقتصادية فحسب، بل هي اجتماعية وسياسية أيضا، والتاريخ يعلمنا أن الجوع كان دائما محركا للثورات، وأن الغضب الذي ينتج عن العوز والفاقة لا يمكن لأي مليشيا أن توقفه.
والمضحك المبكي أن الذين يفرضون الضرائب لإنقاذ البلاد من الانهيار لن يشعروا بتأثيرها، لأنهم يعيشون في عالم آخر، بعيدا عن هموم الناس ومعاناتهم، وحين يحين موعد الانهيار المحتوم سيرحلون بملياراتهم التي نهبوها، ويبقى المواطن الذي أضاع بلاده باستئمانه لهؤلاء، يحصد ما جنوا عليه، أو فلنقل ما جنا على نفسه.