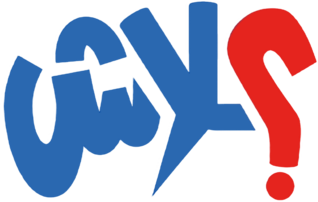الوظيفة الحكومية : الجحيم البارد الذي لايحترق فيه أحد ؟
لطالما كان تأمين المستقبل المشرق الحلم الذي يطارد الشباب منذ الأزل، لكن هذا الحلم، كغيره من الأحلام، يتأرجح بين خيارين لا ثالث لهما: بناء مشروع خاص يتحول إلى قصة نجاح تُلهم الأجيال، أو الانضمام إلى قطيع الموظفين الحكوميين بحثًا عن راتب ثابت وتقاعد مضمون. ومع ذلك، يبدو أن هذين الخيارين، في الواقع الليبي تحديدًا، أشبه بوقوعك بين وهم الثراء في العمل الخاص وأمل الاستقرار الوظيفي الذي يشبه السُّبات في العمل العام.
الآن، دعونا نسأل سؤالًا منطقيًا: ما هو الخيار المثالي؟ وهل تملك خيارًا أصلًا؟
في عالم مثالي، من الطبيعي أن يكون العمل الخاص طريقًا نحو الثراء وجمع الأموال، ويُتيح لك الفرصة لتتحول إلى “مارك زوكربيرغ” النسخة الليبية، تدير مشروعًا ناجحًا وتكسب الملايين. لكن ماذا عن الواقع؟ للأسف، ريادة الأعمال في ليبيا أقرب إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، فأنت بحاجة إلى رأس مال لا تملك منه شيئًا، وبيئة عمل مستقرة، وشبكة علاقات تفتح أمامك الأبواب المغلقة. لكن بدلًا من ذلك، تجد نفسك محاصرًا داخل أسواق غير مستقرة، ونظام اقتصادي يعاقب المبدعين بدلًا من دعمهم.
هل تعتقد أن مجرد فكرة مبتكرة ومبدعة ستقودك إلى النجاح؟ فكّر قبل الوقوع في الفخ، فحتى لو اخترعت منتجًا يُنافس الهاتف الذكي، ستواجه عقبات من نوع آخر، كارتفاع تكاليف المواد الخام وغياب كافة أنواع الدعم. إذًا، يمكننا القول إن العمل الخاص هو مخاطرة، لكن الفارق الوحيد أنك تراهن بكل ما تملك في لعبة لا يعرف أحد قواعدها.
على الجانب الآخر، تبدو الوظيفة الحكومية وكأنها الجنة الموعودة: دخل ثابت، مزايا تقاعدية، وربما تأمين صحي (إذا كنت محظوظًا). لكن لنكن صادقين، ما الذي تنتظره من وظيفة حكومية؟ طوابير طويلة من الروتين الممل والقاتل، تعليمات مكررة من رؤساء عمل متذمرين أساسًا من العمل، وملفات تنتقل من مكتب إلى آخر دون هدف واضح. ومع ذلك، يظل العمل العام هو الحلم الأكبر للكثير من الشباب، ليس لأنه يوفر حياة كريمة، بل لأنه يضمن لك البقاء على قيد الحياة دون الحاجة إلى مخاطرة كبيرة.
لكن المعضلة الحقيقية ليست بين العمل الخاص والعمل العام، بل في إيجاد عمل من الأساس. فالشاب، حتى بعد التخرج بشهادة جامعية تفوق أحلامه، يجد نفسه واقفًا في طوابير البطالة التي لا تنتهي. والأسوأ من ذلك، أن بعضهم، بعد سنوات من الدراسة والتعب، يحصل على وظيفة حكومية لا علاقة لها بمجال دراسته. تخيّل معي طبيبًا يعمل في أرشيف مؤسسة عامة، أو مهندسًا ينظم طوابير الانتظار! هذا ليس خيالًا، بل هو مع الأسف واقع نعيشه.
الحيرة التي يعيشها الشباب ليست مجرد شعور عابر، بل هي نتيجة مباشرة لمنظومة اقتصادية واجتماعية تبدو وكأنها مصممة خصيصًا لتعذيبهم وقهرهم. فالقطاع الخاص يعاني من غياب التشريعات الداعمة، وعدم وجود برامج حقيقية لتمويل المشاريع، في حين أن القطاع العام يئن تحت وطأة الروتين والمحسوبية التي تحكمه.
قد تعتقد أن الحل يكمن في شجاعة الشباب وإبداعهم، لكن حتى هؤلاء الذين قرروا تحدي الواقع عبر التجارة الإلكترونية أو العمل الحر يواجهون تحديات من نوع آخر، مثل بطء الإنترنت، وارتفاع تكاليف الخدمات، وصعوبة التسويق. أما من يحلمون بإصلاح القطاع العام، فهم أشبه بمن يحاولون إعادة بناء سفينة غارقة دون أن يغادروا قاع البحر من الأساس. أو لِنُشَبّه الأمر بأحلام اليقظة التي لا فائدة منها أصلًا.
لكن دعونا نتحدث بصراحة: هل النجاح في العمل الخاص أو العام مجرد حظ؟ أم أن النظام بأكمله بحاجة إلى إعادة بناء؟
الواقع يقول إن النجاح في أي من الخيارين يحتاج إلى منظومة اقتصادية قوية وداعمة. فالعمل الخاص يتطلب قوانين تحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تدريبية تُنمي المهارات، وسوقًا تنافسية تسمح للجميع بالازدهار. أما القطاع العام، فيحتاج إلى إصلاح جذري يحفز الإنتاجية، ويُكافئ الكفاءة، بدلًا من أن يغرق في الروتين والمحسوبية والواسطة ، بالطبع، لا يزال هناك بصيص أمل، فالشباب أثبت مرارًا أنه قادر على التكيف مع الظروف الصعبة. بعضهم أبدع في تحويل التحديات إلى فرص، مثل تأسيس مشاريع صغيرة تعتمد على التكنولوجيا، أو العمل عبر الإنترنت مع شركات عالمية. لكن هذه النجاحات الفردية ليست كافية لتغيير المشهد العام.
في نهاية المطاف، الحلم ليس مجرد الاختيار بين العمل الخاص أو العام، بل بناء بيئة تتيح للشباب تحقيق طموحاتهم دون أن يشعروا بأنهم في سباق ضد الزمن والظروف. الأمل في المستقبل قائم، لكن تحقيقه يتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين الحكومة التي تعيش في الأحلام الوردية، والقطاع الخاص المنعدم، والمجتمع الغارق في التفاهات. فقط حينها، يمكن للشاب أن يختار بين العمل الخاص والعام بناءً على رغباته وطموحاته، لا بناءً على ما تفرضه عليه الظروف القاسية.
في الوقت الحالي، يبدو أن الشباب يُترك في مواجهة معضلة وجودية: هل يخاطر بكل شيء ليصبح رجل أعمال في بيئة طاردة؟ أم ينتظر دوره في طوابير الوظائف الحكومية التي تُشبه انتظار الحافلة في محطة مهجورة؟ الخيار لك، ولكن في كلا الحالتين، لا تنسَ أن تحمل معك جرعة إضافية من الصبر، وربما قليلًا من الحظ.