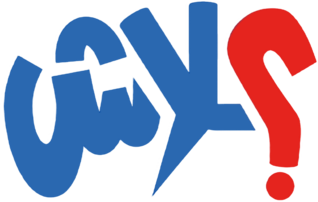الصحافة في ليبيا جريمة بلا شهود ولا محكمة!
في ليبيا اليوم، يبدو أن حرية التعبير قد أصبحت ترفًا زائدًا لا يجرؤ على ممارسته إلا من يملك شجاعة مواجهة المجهول. الصحفيون، الذين يُفترض أنهم حراس الحقيقة، يجدون أنفسهم محاصرين بين الحقيقة واللا حقيقة، في بلد باتت فيه الكلمة أداة خطر تُحارب، لا وسيلة تُستخدم لبناء مجتمع واعٍ ومدرك ومتفهّم.
تخيّل أنك صحفي في ليبيا، حيث كل كلمة تكتبها قد تكون الأخيرة. هذا ليس خيالًا من إحدى الروايات، بل واقع يعيشه الصحفيون يوميًا، إذ يدركون جيدًا أن تقريرًا صحفيًا بسيطًا قد يجعلهم في مواجهة مباشرة مع مجهولين أو مسؤولين غاضبين. يتجسد هذا الخوف في كلمات يرددها كل صحفي عندما يكتب مقالًا أو يعبر عن رأيه: أعيش يومي وكأنني في انتظار حكم غير معلوم لجرم لم أرتكبه. لست خائفًا من الحقيقة، ولكنني خائف من أن أقولها أو أكتبها.
في يوليو 2024، تم اعتقال الصحفي أحمد السنوسي، رئيس تحرير موقع “صدى الاقتصادي”، بعد نشره تقارير تكشف فضائح فساد تورط فيها مسؤولون. وكعادتها، الجهة التي تم فضحها لم تقدم أي توضيح، وكأن الشفافية أصبحت عملة نادرة في دولة تتظاهر بدعم الديمقراطية وحماية الصحفيين. كانت هذه الضربة القاضية لمصادر كافة الصحفيين في المستقبل والحاضر.
حرية التعبير في ليبيا اليوم ليست إلا شعارًا مزيفًا يُرفع في المؤتمرات الدولية، بينما الحقيقة على الأرض تُرسم بدماء الصحفيين. الحكومات المتعاقبة ساهمت في قمع الصحافة عبر قوانين مبهمة تُستخدم لإسكات الأصوات وقمع قلم الحق، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أصبح أداة لملاحقة الصحفيين بدلًا من حمايتهم، إضافة إلى استمرار الاعتماد على قانون المطبوعات الصادر في 29 أكتوبر 1972 تحت الرقم 76 لسنة 1972 ، كان هذا القانون جزءًا من محاولات تنظيم الإعلام والنشر خلال عهد النظام السابق، إلا أنه قُوبل بانتقادات واسعة لاحتوائه على نصوص تُقيد حرية التعبير والصحافة. وقد تضمن قيودًا صارمة على النشر والتعبير، حيث أعطى السلطات الحق في مراقبة المطبوعات ومحاسبة الصحفيين بناءً على محتوى مقالاتهم. ورغم مرور عقود على صدوره، لا تزال مواده تُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في التضييق على الصحفيين والإعلاميين، حتى بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد في عام 2011.
منذ بداية الصراع، تعرض العديد من الصحفيين للقتل، واختُطف آخرون ولم يُعرف مصيرهم حتى اليوم، لتصبح الصحافة مهنة محفوفة بالمخاطر. فعندما تُكمّم الأفواه وتُقيّد الأيدي، يصبح المجتمع ضحيةً للشائعات والمعلومات المضللة. الصحفيون يعيشون في خوف دائم، مما يدفعهم إلى ممارسة رقابة ذاتية مشددة، وهكذا تتحول الصحافة من سلطة رابعة تهدف إلى كشف الحقيقة إلى مجرد صدى لما يريده أصحاب النفوذ. المواطن الليبي، الذي يُفترض أن يكون المستفيد الأول من الصحافة، يجد نفسه محاصرًا بين أخبار مغلوطة ومعلومات مفبركة. في غياب الإعلام الحر، يصبح من المستحيل التمييز بين الحقيقة والكذب، مما يخلق مجتمعًا ضائعًا، تائهًا بين الظلال، غارقًا في قاع الظلمات.
ورغم كل القيود، لا يزال هناك من يؤمن بأن الصحافة هي نبض المجتمع وصوت الحق، وقلمها سيف الحقيقة. الصحفيون الشجعان يواصلون عملهم، مدركين أن القلم قد يكون أقوى من السيف، لكن السيف لا يزال له الكلمة الأخيرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه. الرسالة التي يجب أن تصل إلى كل صحفي وكل مواطن ليبي هي أن الصحافة ليست ترفًا، بل ضرورة من ضرورات بناء وطن ديمقراطي. الكلمة الحرة هي السلاح الحقيقي ضد الفساد والطغيان وتغوّل المسؤولين، وأي مجتمع يُحرم منها يُحكم عليه بالجهل والخضوع للدكتاتوريات الحاكمة.
ومن المفارقات الساخرة التي أصبحت مفروضة، أن الصحفي، الذي يُفترض أنه يسعى لخدمة المجتمع، أصبح يُعامل كعدو. لم يعد يُنظر إليه كعين للمجتمع، بل كخطر يجب القضاء عليه. هذه المأساة تكشف مدى انحراف السلطة الحاكمة عن مسارها، إذ ترى في الحقيقة تهديدًا لوجودها. تكميم الأفواه ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو جريمة في حق المجتمع بأسره. عندما تصبح الحقيقة جريمة، يصبح الكذب هو القانون السائد. لكن، كما يقولون: يمكنك أن تخدع بعض الناس كل الوقت، وكل الناس بعض الوقت، لكن لا يمكنك أن تخدع كل الناس كل الوقت.
ورغم الألم والخوف الذي يلاحق الصحفيين، يبقى الأمل بأن يأتي يوم يتمكن فيه الصحفي الليبي من الكتابة بحرية، دون أن يخشى أن تكون كلماته الأخيرة. الصحافة قد تكون مقيدة اليوم، لكنها لن تُدفن أبدًا، والحقيقة، مهما تأخر ظهورها، ستجد دائمًا طريقها إلى النور، وتسير إليه وحدها.
ويبقى السؤال يتردد في ذهني: هل ستكون هذه كلماتي الأخيرة؟