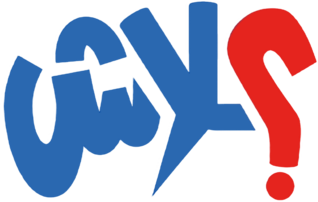قمع بالتقسيط، وبدون فوائد!
في الأساطير الإغريقية، يحكى عن كائنات عملاقة تمتلك عينا واحدة في منتصف الجبهة، تسمى هذه المخلوقات الخرافية بـ"السيكلوب"، ورغم قوتها الجبارة، فإن رؤيتها الأحادية جعلتها تعيش في كهوف معزولة، تهاجم كل من يقترب، لكنها تفشل دائما في رؤية الخطر القادم من الزوايا التي لا تغطيها عينها الوحيدة، فهي لا تنظر إلى أمامها.
اليوم، تشبه الأجهزة الأمنية في ليبيا هذا الكائن الأسطوري؛ فعينها الوحيدة مسلطة على خصوم النظام، بينما تتعامى عن الجرائم التي ترتكب باسمها، أو تلك التي تستهدف حتى مؤيديها ما دامت لا تمس النظام، أو لا تعكر الصفو العام الذي يريد النظام المحافظة عليه ليستمر في قمعه وسرقاته، والأدوات ما زالت ثابتة منذ عهد القذافي؛ شعارات براقة وعبارات رنانة وخلق أعداء وهميين لتحويل اللوم عليهم وفيديو يظهر متهما مرتعدا يقر بجرائم قد لا يكون ارتكبها، والنتيجة ما زالت واحدة على اختلاف الأنظمة؛ ضحية يجرد من إنسانيته، وجلاد يرفع شعار العدالة، وشعب يصفق للعرض لأنه يعتقد أن العدو الوحيد هو من يختلف معه في الفكر أو اللون أو الجنسية.
في 2011، خرج الليبيون ضد نظام شمولي استبدادي، هاتفين بأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والسجن بدون محاكمة والإعدامات الجماعية وتصوير هذه الجرائم وعرضها على الناس في الشاشات؛ هي أفعال مسيئة وجرائم لا تغتفر، لكن الثورة التي أطاحت بالعقيد لم تطيح بثقافة القمع، بل وزعتها كغنيمة بين الجميع، فاليوم، كل جهاز أمني –في الشرق أو الغرب– يملك سجونه السرية، وكل ميليشيا لديها مخرج الفيديوهات الجاهز لتشويه الخصوم ونشر اعترافاتهم، والأمر لا يحتاج إلى دليل؛ فما عليك إلا أن تفتح فيسبوك لترى المسرحية ذاتها تتكرر بطريقة مملة ولكن دون أن نمل منها! صوت محقق غاضب، ومتهم مرتعش يردد كلاما يفترض أن لا نعرف إذا كان حقيقيا أو لا، وتعليقات الجمهور التي تتراوح بين "الله ينصركم عليهم" و"يستاهلوا الكلاب" و "اللي ما يدير شي ما يجيه شي".
واللافت أن كثيرين ممن هتفوا ضد تعذيب النظام السابق وقمعه، صاروا اليوم يبررون ذات الأساليب إذا استخدمت ضد "الآخر"، فالمعارض الذي كان يعتقل في زمن القذافي بتهمة الخيانة وكونه من "الزنادقة" أو "الكلاب الضالة"، يمارس اليوم نفس القمع ضد من يختلف معه فكريا، ولسان حاله يقول إن القمع مستنكر ومستقبح فقط إذا كنت أنا الضحية، أما إذا لبست ثوب الجلاد فهو مبرر.
هذه المفارقة ليست جديدة، فالتاريخ يخبرنا أن الثورات غالبا ما تلتهم أبناءها حين تتحول إلى أنظمة، لكن الجديد في الحالة الليبية هو أن الشعب نفسه –أو جزء كبير منه– صار شريكا في التهام نفسه، فالقمع لم يعد يمارس في أعلى هرم السلطة حصريا، بل من الأسفل أيضا، عبر تشجيع الناس على تصديق الرواية الرسمية، وتبرير الانتهاكات بحجة أو بدونها، والسكوت عن اختفاء الخصوم طالما أنهم "أعداء الوطن".
في علم الاجتماع، تسمى هذه الظاهرة "الاستبداد التشاركي"؛ وهو نظام لا يقوم فقط على قمع السلطة، بل على تواطؤ الضحايا المحتملين الذين يرون في صمتهم اليوم ضمانة لعدم تعرضهم للاضطهاد غدا، لكن التاريخ يثبت أن هذه الضمانة وهمية، ففي العراق، مثلا، كان الشيعة والسنة يتناوبون على دعم النظام القمعي طالما يستهدف الطرف الآخر، لكن الجميع دفع الثمن حين تحولت البلاد إلى ساحة حرب طائفية.
ولا يبعد هذا كثيرا عن النموذج الليبي؛ فالصوفية والسلفية تناوبوا على دعم القمع حين يتعرض له خصومهم، والنتيجة استمرار الجميع في حلقة مفرغة من تناوب القمع، والناس بين ذلك على دين ملوكهم، فكما لم يتعاطفوا مع السلفيين سابقا، هم لا يتعاطفون مع الصوفيين اليوم، وكما كان السلفيون زنادقة سابقا، فالصوفيون قبوريون ومشركون اليوم، والسردية السائدة دائما هي سردية السلطة أو من يمثلها.
المشكلة أن الليبيين، رغم خبرتهم بآلة القمع التي سحقتهم لعقود، ما زالوا يعتقدون أنهم قادرون على ترويضها، فيطالبون بحل الميليشيات، لكنهم يباركون وجودها إذا حمت مناطقهم، ويستنكرون الاعتقالات السياسية إلا إذا طالت الخونة والعملاء، وحين يعرض فيديو لاعتراف "خائن أو عميل"، لا تجد إلى تعليقات الشماتة والتشفي، وهنا تكمن الكارثة؛ فحين يصبح القمع مشروعا إذا نفذ ضد الخصم، فإنه يتحول إلى سيف مسلط على رقاب الجميع، فالجزار الذي يذبح اليوم خصومك، غدا سوف يذبحك أنت حين تختلف معه، وهذا بالضبط ما حدث في عهد القذافي، فكثير من الذين أعدموا أو سجنوا في السبعينيات والثمانينيات كانوا من مؤيدي النظام سابقا بل ومن أركانه ومسؤوليه وممن دعموه ضد النظام الملكي، لم يستنكروا ما حدث قبلهم فتكرر الأمر معهم، ولسان حالهم يقول (ألا قد أكلت يوم أكل الثور الأبيض).
القرآن الكريم يقدم لنا تحذيرا واضحا في هذا السياق حين يقول الله جل وعز (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)، لكننا في ليبيا، نصر على الركون إلى الظالمين طالما أن نارهم لا تحرقنا اليوم، وننسى أن السكوت عن الجريمة مشاركة فيها، وأن القمع لا ينتج أمنا، بل ينتج ثأرا متراكما سينفجر حين تتحول الأدوار، ولو علمنا التاريخ شيئا واحدا فقط؛ فهو أن الأدوار تتحول دائما و"ما يدوم حال".
ربما يأتي يوم ندرك فيه أن عين السيكلوب الواحدة لا تحمي أحدا، وأن العدالة التي تبنى على انتقائية الانتقام ليست عدالة، بل غابة يشرعن فيها القوي افتراس الضعيف، فهل ننتظر حتى نصير جميعا ضحايا؟ أم نتعلم من التاريخ أن من لا ينصر المظلوم اليوم، لا ينصره غدا أحد عندما يكون مظلوما؟ وأن الثور الأحمر لو منع الأسد من التهام أخويه الأبيض والأسود، لما تجرأ على التهامه بعدهما.